52 – أثر العلماء في توعية المجتمعات الإسلامية
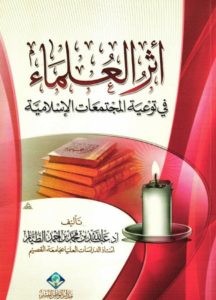
52 – أثر العلماء في توعية المجتمعات الإسلامية pdf
أثر العلماء
في توعية المجتمعات الإسلامية
تأليف
أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(آل عمران:102)، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}(النساء:1) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً}(الأحزاب:70، 71) .
وبعد: فإن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليها حياة الأمة بمجموعها وآحادها فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بها بحيث لو فاتت تلك المصالح الضرورية لآلت حال الأمة إلى الفساد ولحادت عن الطريق الذي أراده لها الشارع، ولذا جاء الحث على
العلم والاهتمام به والترغيب في طلبه في نصوص كثيرة متضافرة، قال تعالى:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة:11)، وقال صلى الله عليه وسلم:(من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)([1]).
ولعل سن الشباب هي خير ما يؤهل فيه الشاب لطلب العلم، وقد يعجز عن إدراك الشيء بعد ما تتقدم به السن لكثرة العوارض والمشاغل وصدق الحسن رحمه الله إذ يقول: (طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر).
وقال علقمة رضي الله عنه:(أمَّا ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاسته أو ورقه). وأوصى لقمان ابنه قائلاً: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحي الأرض الميتة بوابل السماء).
وقال الشاعر:
| نعم المؤانس والجليس كتاب | ** | تخلو به إن ملَّك الأصحاب |
| لا مفشياً سراً ولا متكبراً | ** | وتفاد منه حكمة وصواب |
وقال آخر:
| واعلم بأن العلم أرفع رتبةً | ** | وأجل مكتسب وأسنى مفخر |
| فاسلك سبيل المقتنين له تسد | ** | إن السيادة تقتنى بالدفتر |
| والعالم المدعو حبراً إنما | ** | سماه باسم الحبر حمل المحبر |
| وبضَّمر الأقلام يبلغ أهلها | ** | ما ليس يبلغ بالجياد الضُمَّر |
وقال ابن الجوزي رحمه الله:(لما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصَّل إلا بالتعب والسهر والتكرار، وهجر اللذات والراحة).
ولابد من الأدب مع العلماء واحترامهم وبيان محاسنهم؛ فهم الشموع المضيئة، والأعلام الهادية، والأدلاء على الخير. هم بحر الأمة الدافق، وقلبها النابض، وبلسمها الشافي، هم أهل الصلاح والتقى، أهل الطاعة والعبادة.
وما أحقر بعض الأقزام من أهل الأهواء الذين لا يعرفون للعلماء قدرهم، فيغمزونهم، ويلمزونهم، ويتطاولون عليهم، وما علم هؤلاء أنهم يطعنون الأمة في أعز ما تملك، بل في رصيدها الحقيقي وهم العلماء الذين يعتبر تقديرهم واحترامهم والأدب معهم من صميم ولوازم عقيدة المسلم، ونحن مأمورون حال الاختلاف بالالتفاف حول الكتاب والسنة والرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينهلون من معين الوحيين، وكلّما ابتعد الشباب عن علمائهم تقاذفتهم الأهواء، وفرّقتهم الولاءات والانتماءات، وابتعدوا عن الصراط المستقيم الذي ندعو الله صباح مساء أن يهدينا إليه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}(الفاتحة:6، 7).
فالواجب علينا تجاه علمائنا ـ وهم تاج علماء الأمة الإسلامية في هذا الزمان ـ أن نَصْدُر عن أقوالهم ولاسيما في قضايا الأمة العامة وما يهمها في أمر دينها ودنياها، ولاسيما ونحن نرى مؤامرات الأعداء تحيط بنا من كل حدب وصوب، كل همهم تفريق صف الأمة، وتوهين قوتها، والسعي لإبعاد الشباب عن علمائهم.
وما ضلت أمَّة أعلت قدر علمائها، وتمسكت بمنهجهم، وجعلتهم في مقدمة الركب يقودون سفينة المجتمع إلى شاطئ السلامة لئلا تعصف بها رياح الأهواء والاختلافات التي مزقت الأمة وأضعفتها، وجعلت ولاءها لغير الله ورسوله والمؤمنين.
ووصيتي لنفسي والناس عامة والشباب خاصة أن يلتزموا بأدب الإسلام في انتقاء أطايب الكلام، واجتناب الجرح والسب، والإيذاء بالغمز والهمز واللمز.
وخير ما يعين على ذلك سلوك طريق العلماء الموثوقين الذين لهم قدم راسخة في العلم وهم في بلاد الحرمين تاج علماء الزمان، فليلزم الشاب غرزهم، وليسلم من طرائق الأهواء، ومزالق الشيطان، ومضلات الفتن، ويبتعد عن الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المؤلف
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الزلفي: 8/ 11/ 1427هـ
شريعة الإسلام
المتتبع لنصوص الكتاب والسنة المطهرة واجتهادات علماء المسلمين العباقرة المتمثلة في كتب الفقه الإسلامي وغيرها يجد مصداق ذلك واضحاً جلياً، والأخلاق الإسلامية جاءت كذلك كاملة شاملة حيث أنها لم تدع جانباً من جوانب الحياة الإنسانية جسمية أو روحية دينية أو دنيوية، عقلية أو عاطفية، فردية أو اجتماعية إلا رسمت له المنهج الأمثل في السلوك الرفيع، ووضعت له الدستور القويم الذي يحقق إنسانية الإنسان في أتم وأكمل صورها.
وإذا أردنا أن نجمع صورة كاملة لذلك فعلينا بالنظر في مصدري الإسلام العظيمين كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي علاقة الإنسان بالكون والحياة، وفي علاقته بنفسه جسماً أو روحاً أو عقلاً أو ضميراً أو وجداناً وإحساساً، وفي علاقته بأسرته أباً أو أماً، أو ابناً أو أخاً أو زوجاً، وفي علاقته بأنظمة الحياة الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية أو الدينية، في ذلك كله وفي غيره من حالات الإنسان نجد التشريع الأخلاقي في الإسلام الحنيف قد رسم الطريق في وضوح وشمول.
لقد شاء الله ـ عز وجل ـ للدين الإسلامي الحنيف أن يكون منهجاً إلهياً ربانياً كاملاً شاملاً، عاماً خالداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شاء ـ جل جلاله ـ أن تكون هداية الله ـ عز وجل ـ للناس كافة من كل الأمم ومن كل الطبقات، ومن كل الأفراد، ومن كل الأجيال.
ولقد أفاض العلماء قديماً وحديثاً في وصف الإسلام الحنيف بصفات الجلال والكمال لما بهرتهم أنوار عظمته، وغمرتهم بحار علمه وهدايته وقدسيته، وحسبنا هنا إيراد بعض ما قاله عَلَمٌ من هؤلاء الأعلام وهو الإمام ابن القيم ـ عليه رحمة الله ـ حيث يقول في وصف الشريعة الإسلامية:(فإن الشريعة معناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، ومصالحٌ كلها، وحكمةٌ كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه، وظلِّه في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهُداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤُه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قُرة العيون، وحياةُ القلوب، ولذةُ الأرواح، وبها الحياة، والغذاء، والدواء والنور، والشفاء، والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خَرابَ الدنيا وطيّ العالم رفع إليه ما تبقى من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة)([2]).
وقال ـ عليه رحمة الله ـ في موضع آخر:(الحمد لله الذي نزه شريعته عن التناقض والفساد، وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه في المعاش والمعاد، وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه، ونصبها طريقاً مرشداً لمن سلكه إليه، فهو نوره المبين، وحصنه الحصين، وظله الظليل، وميزانه الذي لا يعول، لقد تعرّف بها إلى ألبَّاء عباده غاية التعرف، وتحبب بها إليهم غاية التحبب، فأنسوا بها منه حكمته البالغة، وتمت بها عليهم منه نعمه السابغة، ولا إله إلا الله الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده بالإلهية، وتوحده بالربوبية، وأنه الموصوف بصفات الكمال، المستحق لنعوت الجلال، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى وله المثل الأعلى، فلا يدخل السُوء في أسمائه، ولا النقصُ والعيبُ في صفاته، ولا العبثُ ولا الجورُ في أفعاله، بل هو منزهٌ في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله بوجه من الوجوه، تبارك اسمه، وتعالى جده، وبهرت حكمته وتمت نعمته، وقامت على عباده حجته.
والله أكبر كبيراً أن يكون في شرعه تناقض واختلاف، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، بل هي شريعةٌ مؤتلفةُ النظام، متعادلةُ الأقسام، مبرأةٌ من كل نقص، مطهرةٌ من كل دنس، مسلمةٌ لاشية فيها، مؤسسةٌ على العدل والحكمة، والمصلحةُ والرحمةُ قواعدها ومبانيها، فهي صراطه المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج، وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية التوحيد، سمحة العمل، لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنه عن شيء فيقول الحجى لو أباحته لكان أرفق، بل أمرت بكل صلاح، ونهت عن كل فساد، وأباحت كل طيب، وحرمت كل خبيث، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق وقوامها الحق، وميزانها العدل وحكمها الفصل، لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي، أو قياس فقيه، أو ذوق ذي رياضة، أو منام ذي دين وصلاح، بل لهؤلاء كلهم أعظم الحاجة إليها، ومن وفق منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليها، فقد أكملها الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك، وحيل المتحيلين وأقيسة القياسيين، وطرائق الخلافيين، وأين كانت هذه الحيل والأقيسة، والقواعد المتناقضة، والطرائق القدد وقت نزول قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً}(المائدة:3)؟
وأين كانت يوم قوله صلى الله عليه وسلم:(لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)([3])، وقوله صلى الله عليه وسلم:(ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أعلمتكموه([4]))([5]) ([6]).
ومهما قال القائلون في وصف الإسلام الحنيف ورسالته الخالدة وشريعته الغراء فلن يبلغوا عشر معشار ما وصفه به رب العزة ـ جل جلاله ـ إذ هو منشئه ومصدره ومنزله، فهو أعلم به علم إحاطة وشمول يناسب علمه المحيط الذي لا يمكن أن تدركه البشرية جمعاء ولا أن تحيط به عقولها القاصرة.
لقد وصفه ـ جل جلاله ـ ووصف كتابه ـ القرآن الكريم أصل الدين الإسلامي الأول وقطب رحاه ـ بجملة من الصفات العامة التي يفنى الزمان ولا تستطيع أن تحيط بكنهها العقول.
وإليك طائفة من هذه الصفات نزجيها على سبيل التمثيل لا الحصر:
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً* فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً}(النساء:174، 175).
وقال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً}(المائدة:3).
وقال تعالى:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}(المائدة:15ـ16).
وقال تعالى:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(الأنعام:153)
وقال تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (النحل:89).
وقال تعالى:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}(الروم:30).
وقال تعالى:{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ} (الشورى:52ـ53)
يمثل الإسلام للمجتمع المسلم ولكل فرد فيه العقائد الصحيحة، والقيم الفاضلة، والمبادئ الشريفة، والأخلاق النبيلة، والشرائع الميسرة الطاهرة، فالإسلامُ إذن قوام شخصية المجتمع المسلم، وحقيقة هويته، ومصدر شرفه وفضيلته، وسبب كرامته، وطريق حريته من عبودية الناس بإخلاص العبودية، وما من منهج في الأرض يحقق هذه الخاصيّات لمعتنقيه سوى الإسلام العظيم.
التحديات التي يواجهها الإسلام
داخلياً وخارجياً
منهج الإسلام الكامل الشامل العظيم يتعرض لتحديات كثيرة في مسيرة الحياة تحديات من داخل المجتمع الإسلامي نفسه، وتحديات من خارج المجتمع الإسلامي، فأما التحديات من داخل المجتمع الإسلامي فتتجسم في الخروج والتمرد عليه جزئياً أو كلياً افتياتاً عليه واتباعاً للأهواء الجامحة والجهالات المردية.
وأما التحديات التي من خارج المجتمع فتتمثل في المحاولات المستمرة والمستميتة من أعدائه للقضاء عليه بإثارة الشبهات والشكوك حوله، ورميه بأبشع التهم، وطعنه بسهام الحقد والكراهية، وأبشع ألوان الطعون، ومن ثمّ كان الإسلام الحنيف ومنذ نزل ـ في معركة دائمة، ومستمرة، ومتجددة، ومستميتة، ومتعددة الجوانب في كل زمان ومكان.
احتياج الإسلام إلى من يواجه به
التحديات الداخلية والخارجية
الإسلام محتاج إلى من يحفظه وينقله وينشره في داخل المجتمع الإسلامي عبر الأجيال، فيعمل على ترسيخ عقائده وسيادة مبادئه ونشر تعاليمه لينفذ إلى القلوب، فيحرك المشاعر، ويفجر في روح المؤمن تلك الطاقة الحية العالية التي تشده شداً محكم الأواصر إلى عقيدته الحقة النيّرة وشريعته الكاملة القويمة، وتعمق فيه روح الولاء لأمته القائدة الرائدة التي أكرمها الله ـ عز وجل ـ بهذه الرسالة الهادية، فحين يتلاقى العقل والقلب، والفكر والشعور، على فهم الإسلام، ووعي قضيته، والولاء لأمته، والتفاعل مع مبادئه ونظمه وحين يكون ذلك الفهم والوعي والولاء والتفاعل عميقاً قوياً شاملاً فلابد أن تنبثق من ذلك روح جديدة تتسم بالإيمان الصادق، والعمل المستمر، والعزيمة القوية، وبذلك تتجدد ثقة المسلمين بمهمتهم القيادية الكبرى، وتتلاشى عوامل الانهزام الفكري والنفسي، وتزول أعراض الشعور بالنقص، وشيوع الضعف والخور، والإخلاد إلى الراحة والاستكانة إلى المتاع العاجل والتعلق بالأهواء والشهوات، والخضوع لسلطة الأقوياء، والانبهار بحضارة الأعداء، وتتقدم من جديد جذوة الكفاح الصامد لنشر الدعوة، ومواجهة التحدي، وقيادة الركب الحضاري النيّر الذي فتح العقول والقلوب، ورفع لواء الكرامة والعدالة والحرية، وبسط راية العلم والمعرفة والسلام في أرجاء المعمورة([7]).
والدين الإسلامي محتاج إلى من ينقله وينشره خارج المجتمعات الإسلامية، فيعمل على تعميم نوره، وبث ضيائه في الآفاق باعتبار الدعوة العامة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والدين الإسلامي محتاج إلى من يعمل على رد الشبهات عنه، وإحباط المكائد التي تحاك ضده من أعدائه، وبخاصة في الميدان الفكري والثقافي لأن أعداء الإسلام في كل عصر يحاولون بكل ما في صدورهم من حقد، وما في وسائلهم من كيد، وما في رؤوسهم من مكر أن يُقصوا الناس عن الهدى، ويصرفوهم عن الإيمان، ويدفعوهم في مسالك الضلال، وطرق الشر، ومهاوي الرذيلة، ودروب الغواية.
إنهم لا يحقدون على شيء كما يحقدون على هذه العقيدة الحقة النيرة التي تحرر الفكر والوجدان، وتطهر القلوب، وتزكي النفوس، وتصحح التصورات، وتقوّم الأوضاع، وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له، كما تخرج البشر من أسر الطغيان، وجور النظم البشرية الفاسدة، وتشويه العقائد الزائغة إلى آفاق الحرية والكرامة والعدالة والاستقامة في ضوء شريعة الإسلام الخالدة.
وأعداء الإسلام يعرفون أنهم لا سبيل لهم إلى التسلط والاستبداد والسيطرة على زمام البشر لا سبيل لهم إلى ذلك، ما دام لهذا الدين بعقيدته وتشريعه وأخلاقه ونظمه وجود قوي، وكيان مكين ودولة وسلطان، ولذلك فإنهم يقذفون بكل قوتهم في المعركة التي يديرونها لتحطيم الإسلام، والقضاء على دعوته، وتشويه رسالته، وتدمير قوته، وتمزيق دولته([8]).
ولقد شاء الله ـ عز وجل ـ لهذا المنهج الإلهي القيم القويم وهو الإسلام الحنيف كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله ـ عز وجل ـ ألا يتحقق في الأرض وفي دنيا الناس إلا بالجهد البشري، وفي حدود الطاقة البشرية، فلا يتحقق منه شيء بمعجزة خارقة.
وإنما يتحقق بأن تحمله جماعة من البشر تؤمن به إيماناً كاملاً، وتستقيم عليه بقدر طاقتها، وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين، وفي حياتهم كذلك، وتجاهد لهذه الغاية بكل ما تملك، تجاهد الضعف البشري والهوى البشري في داخل النفوس، وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى إلى الظلم والوقوف في وجه الهدى والنور المبين.
ولا أدل على ما قلناه من قوله تعالى:{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ}(البقرة:251).
وقوله تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً} (الحج:40).
وقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} (الرعد:11).
علماء الإسلام
هم وحدهم المعنيون لمواجهة
التحديات الفكرية المناوئة للإسلام
من هُم الذين يحملون هذا الدين، ويؤمنون به، ويستقيمون عليه، ويجتهدون لتحقيقه في حياتهم وحياة غيرهم، إنهم في المقام الأول العلماء وأعني بهم العلماء الذين يؤمنون بهذا المنهج إيماناً جازماً، ويؤمنون بأحقيته في قيادة البشرية حيث لا يصلح لها سواه، ويعلمون طبيعة التحديات التي تواجهه، والآثار المدمرة المترتبة على هذه التحديات لو نجحت لا قدَّر الله، العلماءُ المتسلحون بأسلحة العلم حيث يعلمون أن غيرهم من المسلمين لا يملكون أن يفعلوا شيئاً لهذا المنهج الإلهي الكريم رغم ما يملكون من حماس دافق، فالعلماءُ هم الذين يحفظون علم هذا المنهج الإلهي المستمد من مصدريه العظيمين كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلونه للأجيال وينشرونه بين الناس.
والعلماءُ هم الذين يردون الغوي إلى الرشاد، والضال إلى الهدى والمنحرف إلى الصراط المستقيم.
والعلماءُ هم الذين يدفعون عن المنهج الإسلامي الرشيد تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
والعلماءُ هم الذين يقفون حصناً منيعاً، وسداً متيناً في وجه الظلم والإلحاد والزندقة والفساد بشتى صوره وأشكاله وألوانه.
وظيفة العلماء
في المجتمعات الإسلامية
العلماء هم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية عقلها مخافة أن تزل أو تزيغ أو تتيه في أودية الضلال وما أكثرها من أودية.
وهم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية نورها حتى لا يخبو ولا ينطفئ فتعيش في دياجير الظلام الحالك.
وهم الذين يحفظون على الأمة صراطها المستقيم حتى لا تتشعب بها السبل التي تبعدها عن صراط الله.
وهم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية شخصيتها وهويتها حتى لا تميع ولا تذوب.
وهم الذين يحفظون على الأمة ضميرها حتى لا يلوث ولا يدنس بأدناس الحياة، وبالجملة فهم الذين يحفظون على الأمة عزتها، وكرامتها وحريتها، وشرفها، وسائر قيمها المتمثلة في منهجها العظيم.
هذه هي وظيفة العلماء والأمانة الغالية التي ناطها الله ـ عز وجل ـ بأعناقهم، وهذا قدرهم وحظهم في هذه الحياة، وبسبب القيام بها فضّلهم، وشرّفهم، وكرّمهم، وأعزّهم، ولو لم يكن في ذلك سوى قوله صلى الله عليه وسلم:(وإن العالِم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في المــاء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء)([9]).
أقول: لو لم يرد في فضل العلماء سوى هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، فانظر كيف كرّم الله ـ عز وجل ـ العلماء العاملين بعلمهم تكريماً لا يسامى ولا يدانى حينما يتصور أن كل شيء في الكون يستغفر لهم، كل حصاة وكل حجر، وكل حبة وكل ورقة، كل زهرة وكل ثمرة، كل نبتة وكل شجرة، كل حيوان وكل إنسان، وكل حشرة زاحفة، وكل دابة دراجة في الأرض، وكل سابحة في الماء، وكل سارحة في الهواء، وكل ساكنة في السماء، كل هذه وغيرها تستغفر للعلماء العاملين.
وحينما يتصور أنهم أفضل بمراحل كثيرة من العباد المنقطعين للعبادة، وحينما يتصور أنهم ورثة الأنبياء أفضل خلق الله وأقربهم إلى الله ـ عز وجل ـ فأعظم بها رتبة، وأكرم بها منزلة.
الإسلام يهيب بالعلماء
أن يقوموا بوظيفتهم
لقد أهاب الإسلام بالعلماء أن يقوموا بوظيفتهم في توعية المجتمع الإسلامي وتعليمه والحفاظ على مقدساته، والذود عنها ضد المغيرين والمفسدين، أهاب بهم أن يقوموا بهذه الوظيفة خير قيام، وبيّن لهم أنهم إن فعلوا ذلك فهم في أرقى منزلة وأسمى مكانة عند الله ـ عز وجل ـ قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ}(فصلت:33).
وقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} (الأعراف:170).
والإسلام الحنيف يدفع العلماء دفعاً إلى ممارسة وظيفتهم هذه بطرق متعددة منها ما يلي:
أولاً: أوجب عليهم العمل على نشر العلم وبذله وعدم الضنّ به، وبيّن لهم الأجر الجزيل الذي ينتظرهم عن ذلك:
قال تعالى:{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ}(فصلت:33).
وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من علّم علماً فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل بشيء)([10]).
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام:(فضلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم)، ثم قال صلى الله عليه وسلم:(إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)([11]).
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته)([12]).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(نضّر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع)([13]).
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(نضَّر الله امرءًا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه)([14]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)([15]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ـ أيضاً ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)([16]) والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.
ثانياً: أوجب عليهم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحث على ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله ـ عز وجل ـ وأحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (آل عمران:104).
وقال تعالى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}(آل عمران:110).
وقال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(التوبة:71).
وقال صلى الله عليه وسلم:(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)([17]).
ثالثاً: وعدهم بالنصر والتأييد والهداية والتوفيق بمقتضى علمه وحكمته، قال تعالى: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}(الحج:40)، وقال تعالى:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}(العنكبوت: 69). إلى غير ذلك من الآيات.
رابعاً: رهبهم وخوفهم من كتم العلم والضن به، أو القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يترتب على كل ذلك من الفساد الفردي والاجتماعي في المجتمع:
قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (البقرة:159، 160).
وقال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (البقرة:174، 175).
وقال تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ}(آل عمران :187).
وهذه الآية الكريمة وإن كان الكلام فيها عن أهل الكتاب إلا أن فيها كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله:(تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم ـ فعلى العلماء أن يبذلوا ما في أيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئاً، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(من سُئل عن علمٍ فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار)([18]).
وقال صلى الله عليه وسلم:(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابـا منه ثم تدعونــه فلا يستجاب لكم)([19]).
وروى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال:(يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}(المائدة:105)، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه)([20]).
خامساً: أن العلمـاء مسئولون لا محـالـة عن علمهم الذي علمهم الله ـ عز وجل ـ إياه، واستحفظهم عليه لأداء واجبهم تجاه مجتمعاتهم الإسلامية ودينهم الحنيف، أحفظوا أم ضيعوا؟ أدُّوا أم فرَّطوا؟.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه)([21]).
وعنه صلى الله عليه وسلم قال:(يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه)([22]).
وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول:(إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت)([23]).
الإسلام يهيب بالمجتمعات الإسلامية
أن تحافظ على علمائها
هذا من جهة العلماء، أما من جهة المجتمعات الإسلامية فقد أفهمها الإسلام أن علماءها هم سبب رشادها، ونجوم هدايتها، وأنهم إن فُقِدوا صارت المجتمعات الإسلامية في ظلام حالك السواد، فإما وجود العلماء العاملين، وإما الضلال والانحراف وسوء المصير.
روي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وَكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)([24]).
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)([25]).
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:(موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه)([26]).
وكان الحسن البصري رحمه الله يقول:(موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار)([27]).
ومن ثمّ أوصى الإسلام المجتمعات الإسلامية بجملة من الوصايا قبل علمائها منها ما يلي:
أولاً: يوجب الإسلام الحنيف أن يكون في المسلمين هذا الصنف من العلماء ضرورة لوجودهم، وضرورة لحياتهم في شرف وعزة وكرامة، وضرورة لنجاتهم في الآخرة، وذلك بالترغيب في طلب العلم والحث عليه، ومدح العلماء والثناء عليهم، مثل قوله تعالى:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة:11).
وقوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(آل عمران:18).
وقوله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..}(فاطر:28).
وقوله تعالى:{فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}(التوبة:122).
وقوله صلى الله عليه وسلم:(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)([28]).
ومن أجمع الأحاديث وأروعها في هذا الباب حديث أبي الدرداء المشهور الذي يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر)([29]).
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وذلك كله حرصاً على توفر هذا الصنف من العلماء الذين يعملون على توعية المجتمع الإسلامي وإمساك نوره وهداه وروحه عليه.
ثانياً: يوجب الإسلام على المجتمعات الإسلامية المحافظة على علمائها وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم، ويحذر من الاستخفاف بهم أو الزراية عليهم، أو إضاعتهم وعدم المبالاة بهم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه)([30]).
وعن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط)([31]).
ثالثاً: يوجب سؤالهم فيما أشكل، والرد إليهم فيما خفي، خوفاً من الزيغ والضلال، قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (النحل:43).
وقال تعالى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}(النساء:83).
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن عيسى ـ عليه السلام ـ قال: إنما الأمور ثلاثة: أمر يتبيّن لك رشده فاتبعه، وأمر يتبيّن لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فردّه إلى عالم)([32]).
رابعاً: يوجب طاعتهم وعدم مخالفتهم ما دامت في حدود طاعة الله ـ عز وجل ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (النساء:59).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:(قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وأبو العالية، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، ومجاهد في إحدى الروايتين عنه {أُوْلِي الأَمْرِ} هم العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
وقال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الأخرى، وزيد بن أسلم، والسدي، ومقاتل: هم الأمراء وهو الرواية الثانية عن أحمد.
والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء..أ.هـ)([33]).
ولو قيل: إنها تشمل العلماء والأمراء لكان أولى.
ما يجب على العلماء
حتى يؤدوا وظيفتهم على الوجه الأكمل
لما يترتب على تفريط العلماء من انحراف العامة وضلال الأمة كان إثمهم أعظم، ووزرهم أكبر وأخطر، وعذابهم أشد وأبقى، لذلك قال صلى الله عليه وسلم موضحاً مصير المفرطين من العلماء، وما ينتظرهم من سوء العاقبة وعذاب الآخرة:(يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن، فإذا قرؤه قالوا قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا، قال: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار)([34]).
لذلك فمن اللازم للعلماء لكي يؤدوا وظيفتهم على أكمل الوجوه وأحسنها أن يكونوا في أعلى مستوى من الصلاح في خاصّة أنفسهم وفي سلوكهم بين الناس، ولن يتأتى لهم ذلك إلا إذا تحلّوا بجميع الفضائل جملة، وتخلُّوا عن جميع الرذائل جملة، وإذا كان هذا الأمر واجباً على كل مسلم، فهو في حق العلماء ألزم وأوجب، لأنهم الأئمة والقدوة في كل عصر ومصر، وفي كل زمان ومكان ـ والناس تبع لهم ينظرون إليهم على أنهم الهداة المرشدون إلى الطريق المستقيم، ويحلونهم من قلوبهم محلاً رفيعاً، إذا قالوا أصغوا إليهم بآذانهم، ووعت عنهم قلوبهم، وحكت عنهم ألسنتهم، وهم بهم مقتدون.
ومن ثمّ كان لصلاح العلماء أكبر الأثر في صلاح الناس، ولفسادهم كذلك أكبر الأثر في فسادهم، وقد أُثرت عن الصحابة والتابعين روايات كثيرة بهذا المعنى.
فقد روي عن مالك رحمه الله أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (اعلموا أنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم)([35]).
وروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال:(لله قراء، وللشيطان قراء، وصنفان إذا صلحا صلح الناس؛ السلطان والقراء)([36]).
وكان يقول أيضاً:(الأعمال السيئة داء، والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء)([37]).
يجب إذاً أن يكون العلماء على أعلى مستوى من الصلاح في أنفسهم وفي سلوكهم بين الناس حتى يتحقق فيهم الإمامة والقدوة، ويؤدوا وظيفتهم على أكمل الوجوه وأحسنها، يجب أن ينضح علم الإسلام على سلوكهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم هدىً وتقى وزهداً وتواضعاً وعفة وورعاً وسكينة وخشوعاً ووقاراً بحيث يظهر كل ذلك في هيئتهم وسيرتهم، وسرهم وعلانيتهم، وسكونهم وحركتهم، ونطقهم وسكوتهم حتى يُعرفوا بسيماهم، وحتى يكبر العلم الذي يحملونه في أعين الناس عندما يرون أثره في هؤلاء العلماء، فيكونون لهم سامعين طائعين.
كل خلق فاضل دعا إليه الإسلام فهو في حق العلماء أوجب، وكل خلق سيء نهى عنه الإسلام، فالنهي في حق العلماء آكد، ونريد هنا أن نؤكد فقط على بعض الصفات المهمة جداً للعلماء حتى يقوموا بوظيفتهم، وحتى تؤتي جهودهم ثمارها.
أولاً: الإخلاص والتجرد لله ـ عز وجل ـ:
ومعنى الإخلاص: تجريد العمل لله ـ عز وجل ـ بحيث لا يريد به الإنسان شيئاً آخر سوى مرضاته ـ عز وجل ـ لا يريد به المحمدة عند الناس، ولا يريد به الحياة، ولا يريد به المنصب، ولا يريد به المال، ولا يريد به الرئاسة والشرف، بل يريد به وجه الله ـ عز وجل ـ أولاً وأخيراً وجه الله سبحانه فحسب.
ومن المعروف أن الله ـ عز وجل ـ قد أوصى عباده جميعهم العلماء منهم وغير العلماء بهذا الوصف في جميع أعمالهم، وبيّن لهم أنه لن تقبل منهم طاعة من الطاعات إلا إذا توفر فيها الإخلاص والتجرد. قال تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} (الزمر: 2،3). وقال سبحانه:{وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (البينة:5)
كما بين لهم ـ جل جلاله ـ أن عدم الإخلاص في أي طاعة من الطاعات يهبط بها، بل ويجعلها معصية شائنة لا ينال صاحبها منها إلا الفشل والخسار بعد التعب في تحصيلها والكد في أدائها. قال تعالى:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(الماعون:4ـ8).
وقال ـ جل جلاله ـ{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا}(البقرة:264).
وفي آية جامعة عامة يقول سبحانه:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(هود:15، 16).
وهكذا كل عمل ديني أخروي يقصد به الدنيا لا يكون لصاحبه أدنى نصيب من الأجر، بل ينقلب معصية عليه وزرها ووبالها لأنه غلف عمل الدنيا بغلاف الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة في الدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب)([38]).
وهذه الأحكام العامة عامة وشاملة في العلماء وغير العلماء، ولكن الإسلام لم يقف عند هذا الحد ـ ولو وقف لكان في ذلك كفاية وبلاغ ـ ولكنه خص العلماء في هذا الموضوع بجملة من الوصايا توجب إخلاص عملهم لله ـ عز وجل ـ، والتحذيرات من عدم الإخلاص والتجرد، فإن في ذلك وبالاً عليهم وأي وبال!!.
ونكتفي بأن نسوق هنا بيان الحافظ الجليل ابن رجب الحنبلي ـ عليه رحمة الله ـ ففيه كفاية عن غيره.
قال رحمه الله:(طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد أفحش من طلبها بالولاية والسلطان والمال، وأقبح وأشد فساداً وخطراً، فإن العلم والعمل والزهد، إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه.
قال الثوري: إنما يُطلبُ العلم ليتقي الله به، فمن ثمّ فضل، لولا ذلك لكان كسائر الأشياء.
فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضاً نوعان: أحدهما: أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة، وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) يعني ريحها ([39]).
وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به، والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك.
فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة.
ولهذا كان أشد الناس عذاباً في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها.
فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به، فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه.
وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، فإن ذلك خداع قبيح جداً.
والثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق، والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق ويخضعون له، ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم، ونحو ذلك، فهذا موعده النار لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه.
فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم:(من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السّفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار)([40])، وفي رواية: (فهو في النار)([41]).
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار)([42]).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:(لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه)([43]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه … وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت! ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار)([44]) ) ا.هـ.([45]).
أقول: ومما ورد في ذلك أيضاً من الأحاديث الشريفة ما روي عن أبي سعد بن أبي فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)([46]).
ثانياً: موافقة الأعمال والأحوال والأقوال:
دلالة صدق العالم عند الناس فيما يدعوهم إليه، وما يوصيهم به، ويحثهم عليه هي أن تكون أفعاله وأحواله مطابقة لأقواله ووصاياه، فلا يكذب فعله قوله، ولا يخالف باطنه ظاهره، وبعبارة أخرى لا يأمر بمعروف إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن منكر إلا كان أول منته عنه، حينئذ فقط يؤثر في الناس، ويستميلهم إلى ما يريد، أما إن كذب فعله قوله، وخالف باطنه ظاهره، وأمر بمعروف لا يفعله، ونهى عن منكر وهو ملوث به متلطخ فيه، فأنى يستجاب لقوله؟ وكيف يتأثر به الناس؟.
إن ذلك أمر أشبه بالمحال، لأنه أصبح موضع الشك والارتياب، وانتفت عنه ثقة الناس، فلا تجاوز كلماته صماخ الآذان بل يصبح ويمسي كمن يصبح في واد، وينفخ في رماد، ولا أثر لقوله ولا متأثر به، وحقاً ما قال مالك ابن دينار رحمه الله:(إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، كما يزل القطر على الصفا)([47]).
إن شر ما يمنى به الإسلام حقاً هو أولئك الذين يأمرون بخير ويتركونه وينهون عن شر ويفعلونه، فأقوالهم أقوال الصديقين، وأفعالهم أفعال الشياطين، ورضي الله تعالى عن الإمام علي بن أبي طالب حينما قال: (قصم ظهري رجلان: عالم متهتك، وجاهل متنسك، فالجاهل يغر الناس بتنسكه، والعالم يغرهم بتهتكه)([48]).
أجل؛ فإن دعوة العلماء إلى الخير والمخالفة عنه في سلوكهم هي الآفة التي تصيب الناس بالشك والارتياب لا في الدعاة وحدهم، ولكن فيما يدعون إليه وهو الإسلام الحنيف أيضاً لأنهم يسمعون قولاً جميلاً، ويشهدون فعلاً قبيحاً فتتبلبل أفكارهم، وتتملكهم الحيرة بين القول الجميل والفعل القبيح، وبالتالي يبدأ فقدهم للثقة في العلماء أولاً ثم فيما يدعون إليه ويمثلونه ثانياً.
لقد استنكر الإسلام أشد الاستنكار أن يقول الإنسان ما لا يفعله، وقبّح هذا الخلق وهذه الصفة أشد تقبيح، وتوعد على ذلك أشد العقاب، يقول سبحانه وتعالى مخاطباً علماء بني إسرائيل وأحبارهم في أسلوب تقريع وتوبيخ واستنكار لما اتصفوا به من انفكاك بين قول الخير والبرّ وفعله من أنفسهم {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ}(البقرة:44)، ويقول سبحانه وتعالى في بعض المؤمنين الذين تشبهوا بأولئك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}(الصف:2، 3).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟،فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به)([49]).
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه)([50]).
وإنما كانت مخالفة أفعال العلماء لأقوالهم محل هذا الاستنكار وسبب هذا التعذيب لأنهم عصوا ربهم عن علم وإصرار، ولكونهم قدوة الناس فقد عصى بمعاصيهم خلق كثير، إذ كانوا بمواقفهم هذه سبباً للجرأة على حرمات الله والتفلت من هدى الله، فهم بهذا أئمة ضلال في أزياء المتقين وشياطين رحماء في ملابس المتنسكين!!
وفيهم يقول ابن القيم رحمه الله:(علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق)([51]).
ثالثاً: الشجاعة الأدبية:
يجب أن يكون العلماء على حظ كبير جداً من الشجاعة الأدبية أو المعنوية بمعنى أن يجهروا بالحق، وينطقوا بالصدق لا يخافون إلا الله ـ عز وجل ـ ولا يرجون سواه، هدفهم وغايتهم ومنتهى أملهم سيادة الحق أعني سيادة الإسلام وهيمنته على كل ما سواه، سواء في ذلك رضي كل الناس، أو سخط كل الناس، وسواء في ذلك عاش حياته سعيداً قرير العين أو شقياً لا يقر له قرار، فقد أوقف حياته على الدعوة إلى الله، ونذر نفسه لمرضاة الله ونصرة دينه الحنيف.
وليس معنى ذلك أن يبدأ العالم الناس بالمخاشنة والمغالظة بأمر بعيد عن وظيفته في نشر الإسلام والرد عنه فيثير حفائظهم، ويوقد أحقادهم ويلهب غضبهم، وإنما معناه أن يجهر بالحق مخلصاً لوجه لله، فإن وافقه الناس في الحق الذي دعاهم إليه فبها ونعمت، وإن خالفوه وعاندوه ثبت على حقه حتى ولو عادوه لذلك وكرهوه ونصبوا له، قال تعالى:{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً}(الأحزاب:39). ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الجهر بالحق في إخلاص وأدب مهما كان ثمن ذلك الجهر.
كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ويوصيهم ألا يدعوا إعلان الحق والجهر به ما دام في مصلحة سيادة الحق وانتشار الخير والفضيلة، وإزالة ومحق الشر والرذيلة حتى ولو ضحى الإنسان في ذلك بماله أو بجاهه أو بنفسه أو بكل ذلك دفعة واحدة.
روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:(بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم…. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)([52]).
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:(أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع ….. ومنها قوله: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مراً، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم..)([53]).
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كلمة الحق الشجاعة في وجه الطغيان أعظم أنواع الجهاد، فقد سأله أحد الصحابة قائلاً يا رسول الله: أي الجهاد أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم:(كلمة حق عند سلطان جائر)([54]).
كما يعتبر أن من تحقير الإنسان نفسه وإذلالها وإهانتها أن يرى أمراً يستطيع فيه أن يعلن بالحق ثم لا يفعل مخافة الناس!! .
كما يبين صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث أن الجهر بالحق لا يبعد نفعاً قدره الله ـ عز وجل ـ للإنسان، ولا يجلب شراً لم يقدره الله ـ عز وجل ـ عليه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً، فكان فيما قال:(… ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه)، فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا)([55]).
وهكذا يجب أن يكون العلماء حتى يؤدوا الأمانات التي وضعها الله ـ عز وجل ـ في أعناقهم وناطها بهم على الوجه الأفضل المطلوب.
رابعاً: الصبر على الأذى:
من المعروف أن العالم يدعو إلى الأخذ بدين الله ـ عز وجل ـ والتمسك بشرعه القويم، ومن المعروف كذلك أن الناس جميعاً ليسوا على دين واحد، ولا على طريقة واحدة ولا على مذهب واحد، وإنما يختلفون أدياناً ومذاهب وطرائق، ومن هنا فإن العالم سوف يلاقي الأمرين في وظيفته!!.
سوف يلاقي الكافر والمشرك والملحد والزنديق والمنافق، وسوف يلاقي الباطل على أيديهم يتبجح، والشر ينتفش، والرذيلة تستشري، وسوف يلاقي الأذى يصيبه من كل هذه الجهات، وبمختلف الوسائل، وسوف يلاقي العالم أيضاً ممن لم ينالوا من التربية والعقل ما يؤهلهم لأن يدركوا مقاصده ويفهموا أفكاره فيعارضوه عن جهل، مصرين على التمسك بما وجدوا عليه آباءهم من قبل ولو كانوا على غير هدى أو ضلال مبين.
وسوف يلاقي من يقفون له بالمرصاد فيعارضونه في أفكاره، ويصادمونه في دعوته، ويقابلون كلامه بالسخرية والاستهزاء، ويتتبعون عوراته، ويتسقطون هفواته، وسوف يلاقي أيضاً الحاقدين والحاسدين الذين يتألمون أشد الألم إذا ارتفع واحد من الناس عنهم، ولا يجدون راحتهم إلا إذا أنزلوه من مكانته بالطعن عليه، والتشهير به، واختلاق الأكاذيب في حقه، والإزراء لطريقته.
وكل هؤلاء وأولئك قد يعارضون العالم بالباطل، ويثيرون من حوله الزوابع والأعاصير، فإذا لم يتسلح بضبط النفس، وقوة التحمل، والصبر على الأذى حتى يجعل تلك المكاره دبر أذنيه، ومواطئ نعليه فإنه سيضطرب، وينفعل انفعالاً يسد عليه مسالك تفكيره، ويقعده عن عمله ووظيفته، أو على الأقل يورثه البطء والتكاسل فيها، وعدم التحمس لها..!!
أما إذا صبر على الأذى، وراض نفسه على تحمله فإنه يستطيع أن يستمر في دعوته، ويمضي بها قدماً بقلب ثابت ونفس مطمئنة، ولاشك أن النصر والظفر في النهاية لمن صابر وصبر.
لما حكى الله ـ عز وجل ـ قصة لقمان في القرآن الكريم بين أنه قرن الأمر بالصبر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر {وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} (لقمان:17).
وما أمر لقمان ولده بالصبر عند أمره له بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لعلمه بأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله من الناس الأذى والعنت والمشقة، فلابد له من الصبر الذي لا جزع معه ولا تردد ولا نكوص.
وعندما نطالع القرآن الكريم بتدبر وإمعان وروّية نجد أن الله ـ عز وجل ـ يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الصبر ويوصيه به ويحثه عليه، وخاصة في أوائل السور نزولاً تلك التي كان يربي الله ـ عز وجل ـ بها رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بالدعوة على أكمل الوجوه وأحسنها، ففي سورة المدثر وهي من أوائل السور نزولاً يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم:{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ}(المدثر:1ـ7).
وفي سورة المزمل يقول سبحانه وتعالى بعد عدة توجيهات من أجل الدعوة {وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً * رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً * وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً}(المزمل:8 ـ10).
وفي سورة الإنسان يقول سبحانه وتعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً * فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} (الإنسان:23ـ24).
ويستمر هذا التوجيه الإلهي الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن يتحمل الأمانة الغالية أمانة التبليغ والدعوة يستمر في آيات كثيرة وفي مناسبات عديدة.
فمرَّة يطلب منه سبحانه ألا يستخفنَّه تكذيبهم إياه وإيذاؤهم له على عدم الصبر، بل عليه بالصبر موقناً بوعد الله إذ يقول سبحانه {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ}(الروم:60).
ومرة ثانية يوصيه بألا يضيق صدره بمكر الماكرين، وكيد الكائدين وخيانة الخائنين، وإنما عليه أن يمضي في دعوته غير عابئ بهؤلاء ولا هؤلاء، فإنما يدعو لله ـ عز وجل ـ لا لنفسه، والله ـ عز وجل ـ هو الحافظ له من الماكرين والكائدين والخائنين، فيقول تعالى له: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (النحل:127).
وقد يقع عليه الأذى لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة معروفة وهي {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}(النحل: 128).
وكل ما هو موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وبهذا الخصوص هو موجه أيضاً إلى العلماء الذين هم خلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء وسائر الدعاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
فلا يمكن أن يقوم بوراثة النبوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده، والصبر جنته وسلاحه، والصبر ملجأه وملاذه، (ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر)([56]).
هذه هي أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في العلماء حتى يؤدوا واجبهم في توعية المجتمعات الإسلامية على الوجه الأكمل، والله تعالى هو الموفق والمعين، ولا حول ولا قوة إلا به جل جلاله.
الفهرس
| الموضوع | الصفحة |
| المقدمة | |
| شريعة الإسلام | |
| التحديات التي يواجهها الإسلام داخلياً وخارجياً | |
| احتياج الإسلام إلى من يواجه به التحديات | |
| علماء الإسلام هم وحدهم المعينون لمواجهة التحديات | |
| وظيفة العلماء في المجتمعات الإسلامية | |
| الإسلام يهيب بالعلماء أن يقوموا بوظيفتهم | |
| الإسلام يهيب بالمجتمعات الإسلامية أن تحافظ على علمائها | |
| ما يجب على للعلماء حتى يؤدوا وظيفتهم على الوجه الأكمل | |
| الأول: الإخلاص والتجرد | |
| الثاني: موافقة الأعمال والأحوال والأقوال | |
| الثالث: الشجاعة الأدبية | |
| الرابع: الصبر على الأذى | |
| الفهرس |
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) رواه البخاري ـ كتاب العلم (1/125 رقم69 )، ومسلم ـ كتاب الزكاة (5/241 رقم1721).
([2]) إعلام الموقعين لابن القيم (ج3/ص3).
([3]) رواه ابن ماجة (1/50 رقم43)، وأحمد (35/7 رقم16519)، والحاكم (1/321 رقم303) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4369).
([4]) رواه عبد الرزاق في مصنفه (11/125) ولفظه:(إلا قد بينته لكم)، ولم أقف على صحته.
([5]) إعلام الموقعين لابن القيم (ج3/ ص206،207).
([6]) وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه..)(رواه ابن أبي شيبة (8/129)، وعبد الرزاق في مصنفه (11/125) والبيهقي في شعب الإيمان (26/310 رقم 9989) واللفظ له، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/865 رقم2866).
([7]) كتاب لمحات في الثقافة الإسلامية لعمر عودة الخطيب ص6، 7.
([8]) كتاب لمحات في الثقافة الإسلامية لعمر عودة الخطيب ص118 بتصرف.
([9]) رواه أبو داود (10/49 رقم 3157)، والترمذي (9/296 رقم 2606)، وابن ماجة (1/259 رقم 219)، وأحمد (44/192 رقم 20723)، وابن حبان (1/171 رقم 88)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6297).
([10]) رواه ابن ماجة(1/279رقم 236)وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(ج1رقم 959)
([11]) رواه الترمذي (9/299 رقم2609)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4213).
([12]) رواه الطبراني في الكبير (7/99 رقم7346) بإسناد لا بأس به، وخرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1رقم 86)، وقال: حديث حسن صحيح.
(4) رواه أبو داود (10/76 رقم3175)، والترمذي (9/259 رقم2581)، وابن حبان (1/136 رقم6) وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وخرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1 رقم89) وقال حديث حسن صحيح.
([14]) رواه أبو داود (3/322 رقم3660)، والترمذي (5/33 رقم 2656) وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1/90).
([15]) رواه مسلم ـ كتاب العلم (13/164) رقم (4831).
([16]) رواه مسلم ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (13/212) رقم (4867).
([17]) رواه مسلم ـ كتاب الإيمان (1/167) رقم (70).
([18]) رواه أبو داود (10/73رقم3173)، وابن ماجة (1/308 رقم260)، وأحمد (15/296 رقم7255) ورواه الحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (1/335 رقم315)، والطبراني في الكبير (7/392) والبيهقي في شعب الإيمان (4/266 رقم1702)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1 رقم 120).
([19]) رواه الترمذي (8/75 رقم2095)، وحسنه الألباني في جامع الترمذي (4/468 رقم2169).
([20]) رواه الترمذي (8/73 رقم2094) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(4/88رقم 1564)
([21]) رواه الترمذي (8/443 رقم2341)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1، رقم126)
([22]) رواه البخاري ـ كتاب بدء الخلق (11/46 رقم3027).
([23]) جامع بيان العلم وفضله (1/2).
([24]) رواه البخاري ـ كتاب العلم (1/141 رقم77).
([25]) رواه البخاري ـ كتاب العلم (1/176رقم 98)،ومسلم ـ كتاب العلم (13/160رقم4828).
([26]) إحياء علوم الدين (1/11).
([27]) جامع بيان العلم وفضله (1/153).
([28]) رواه البخاري ـ كتاب العلم (1/126رقم69)، ومسلم ـ كتاب الزكاة (5/241رقم 1721).
([29]) رواه أبو داود (10/50 رقم3158)، والترمذي (9/243رقم2570)، وابن ماجة (1/259 رقم219) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6297).
([30]) رواه أحمد (46/239 رقم 21693)، حسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم5443).
([31]) رواه أبو داود(12/473 رقم4203)،وحسنه الألباني في سنن أبي داود (4/261رقم4843).
([32]) رواه الطبراني في الكبير بسند لا بأس به (9/195رقم 10623)، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف جداً (ج1 رقم116).
([33]) إعلام الموقعين لابن القيم (1/37).
([34]) رواه أبو يعلى (13/440 رقم6556)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج7 رقم3230).
([35]) جامع بيان العلم وفضله (1/185).
([38]) رواه أحمد (43/234 رقم20276)، وابن حبان (2/300 رقم406)، والحاكم (18/267 رقم 8009)، والبيهقي في شعب الإيمان (14/358 رقم6566)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1 رقم23).
([39]) رواه أبو داود (10/82 رقم 3179)، وابن ماجة (1/294 رقم 248)، وأحمد (17/145 رقم 8103) والحاكم (1/277 رقم264) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم،وابن حبان (1/152 رقم78)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1رقم105).
([40]) رواه الترمذي (9/255 رقم2578)، وحسنه الألباني في جامع الترمذي (5/32 رقم 2654).
([41]) رواه ابن ماجة (1/295 رقم249)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6382).
([42]) رواه ابن ماجة (1/296 رقم250)، وابن حبان (1/151 رقم77)، والبيهقي (4/290 رقم1725) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1 رقم107).
([43]) رواه الدارمي في سننه (1/ 288 رقم261).
([44]) رواه مسلم ـ كتاب الإمارة (10/9) رقم (3527).
([45]) عن كتاب شرح حديث:(ذئبان جائعان…) لابن رجب الحنبلي، وهو مدرج ضمن كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/175، 176) ط دار الكتب العلمية ـ بيروت 1398هـ.
([46]) رواه الترمذي(10/429 رقم3079)، وحسنه الألباني في سنن الترمذي(5/314 رقم3154).
([49]) رواه البيهقي(10/463 رقم4757)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج1 رقم125)
([50]) رواه البخاري ـ كتاب بدء الخلق (11/46 رقم3027)، ومسلم ـ كتاب الزهد والرقائق (14/261 رقم 5305).
([52]) رواه البخاري ـ كتاب الأحكام (22/140 رقم6660)، ومسلم ـ كتاب الإمارة (9/373 رقم3426).
([53]) رواه أحمد (43/413 رقم20447)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/199 رقم 2166)
([54]) رواه النسائي (13/121رقم4138)، وصححه الألباني في سنن النسائي (7/161 رقم4209).
([55]) رواه ابن ماجه (12/11 رقم3997)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (2/1328رقم 4007)
([56]) رواه البخاري ـ كتاب الزكاة (5/318 رقم 1376)، ومسلم ـ كتاب الزكاة (5/274 رقم 1745).
مواضيع ذات صلة
-
وجعلنا نومكم سباتا – خطبة الجمعة 6-8-1445هـ....
الجمعة 6 شعبان 1445هـ 16-2-2024م قراءة -
141- أسئلة وأجوبة حول الجنائز والمقابر.....
السبت 2 ربيع الثاني 1446هـ 5-10-2024م قراءة -
مكانة الأخ وشيء من حقوقه – خطبة الجمعة 19-6-1446ه....
الجمعة 19 جمادى الآخرة 1446هـ 20-12-2024م قراءة -
التسول ظاهرة مقيتة ودخيلة – خطبة الجمعة 15-8-1446....
الجمعة 15 شعبان 1446هـ 14-2-2025م قراءة -
بشراكم يا أهل الفجر – خطبة الجمعة 27-5-1446هـ....
الجمعة 27 جمادى الأولى 1446هـ 29-11-2024م قراءة -
الأشهر الحرم وأداء فريضة الحج – خطبة الجمعة 16-11....
الجمعة 16 ذو القعدة 1445هـ 24-5-2024م قراءة
